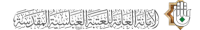جريمة الاختفاء القسري في زمن البعث
أ.د. حسين الزيادي
جريمة الاختفاء القسري من الجرائم الحديثة نسبياً ذات الطبيعة المستمرة[1] التي لا تسقط بالتقادم، ولا تعتد بالحصانات الدبلوماسية، فهي جريمة لها أركانها وعناصرها وآثارها، وتعد انتهاكاً صارخاً وخطيراً لحقوق الإنسان، وهي تختلف عن جرائم مقاربة لها، كأخذ الرهائن، والقبض، والاحتجاز، والاختطاف، من حيث صفة الجاني ومشروعية الفعل وطبيعة السلوك الإجرامي اللاحق والنتيجة الجرمية والعلاقة السببية، وتمتاز أركان الجريمة بوجود ركن رابع وهو الركن الدولي، فضلاً عن الركن المادي والمعنوي والشرعي، مما يجعلها تقع في ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وعلى الرغم من الاختلاف البسيط في تعريفها بين القانون الدولي الإنساني الذي لم ترد فيه الجريمة بشكل واضح وصريح، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 133/47 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992م، فالجميع يتفق على أنَّها تعني إلقاء القبض على أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل الدولة أو منظمة سياسية، أو إنَّها تتم بموافقة الدولة ومباركتها أو بسكوتها عن هذا الفعل، وهذا يعني موافقتها الضمنية عليه، ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم، بهدف عدم إعطائهم الحق في حماية القانون، وهذا يعني تغييب الشخصية القانونية للفرد ومنعه من الحصول على ضمانات التقاضي، وبحسب إعلان الأمم المتحدة بشأن الاختفاء القسري: إنَّ الاختفاء القسري يشكّل انتهاكاً للحرية والأمن الشخصي، والحق في عدم إخضاع الفرد للتعذيب، والمعاملة أو العقوبة الأخرى القاسية أو اللاإنسانية، وأعتبر المؤتمر الدولي الرابع والعشرون للصليب الأحمر في 1981م إنَّ الاختفاء القسري يشتمل على انتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية كالحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية والحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية.
جريمة منظمة:
على وفق النظام الأساس للمحكمةً الجنائية الدوليــة المعتمد فــي 17 تمـوز 1998م الذي حــدد الجرائم ضـد الإنسانية، فجريمة الاختفاء القسري ترقى إلى أن تعد جريمة ضد الإنسانية متى ما ارتكبت في إطار هجوم ممنهج واسع النطاق ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، كما نص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية العليا الذي دخل حيز التنفيذ عام 2002م والاتفاقية الدولية لحماية الأفراد من الاخفاء القسري التي تم اعتمادها من الجمعية العامة في عام 2006م على أن الاختفاء القسري يُعد جريمة ضد الإنسانية في حالة ارتكابه في ضمن هجوم واسع النطاق أو ممنهج على مجموعة من السكان المدنيين، ولأسر الضحايا المطالبة بالتعويض ومعرفة مصير أقاربهم ممن نالتهم الجريمة.
على الرغم من إن حالات الاختفاء القسري كانت سياسة ممنهجة وأسلوباً استراتيجياً لنظام البعث منذ عام 1968م إلى عام 2003م، إذ تشير تقديرات لجنة الأمم المتحدة المعنية إلى أن ما يصل إلى 290,000 شخص قد غُيبوا قسراً في العراق، بما في ذلك حوالي 100,000 كردي كجزء من حملة الإبادة الجماعية التي شنها نظام صدام في كردستان العراق، إلا أن ذروة جريمة الاختفاء القسري في العراق كانت أثناء الانتفاضة الشعبانية ضد سلطات البعث وقياداته الأمنية والحزبية التي تلت انسحاب الجيش العراقي من دولة الكويت عام 1991م، فكان احتجاز المواطنين المشاركين بالأحداث واخفائهم يجري على قدم وساق لاسيما في محافظات البصرة وميسان والناصرية، فالجريمة اتخذت طابع ما يسمى بالجريمة المنظمة التي تشترك بها أكثر من جهة.
تقوم جريمة الاختفاء القسري في العراق على الأغلب بقيام مجموعة من الأشخاص مسلحين بسلاح خفيف (مسدس) يكون على الأغلب مخفي تحت الملابس، ينتمون لجهة أمنية باقتياد الضحية وأقناعه بالذهاب معهم، وإنَّ الأمر يتعلق بالحصول على معلومات بسيطة، ولا يستغرق إلا دقائق قليلة، وفي حالة ممانعة الضحية يتم اللجوء إلى العنف، ومن هنا تبدأ الجريمة حيث يقوم المجرمون بعد خطف الضحية بقطع جميع الروابط التي يمكن للضحية أن يستغلها للتواصل مع المجتمع، وفي الوقت نفسه لا تعطى أية معلومة لذوي المفقود، فيعيشون في دوامة من الشك والقلق وعدم اليقين، وأتذكر في بداية التحاقي بالدراسة الجامعية في جامعة بغداد عندما كنت طالباً في المرحلة الأولى وتحديداً عام 1989م وفي أحدى المحاضرات دخل علينا مسؤول أمن الكلية بصحبة أثنين من مساعديه ونادى باسم أحد الطلبة الذي كان من مدينة الناصرية، وطلب منه أخذ كتبه معه، وكانت هذه المرة الأخيرة التي رأينا فيها صديقنا، حاول أهله السؤال عنه لكن دون جدوى وأستمر الحال حتى تخرجنا بعد أربع سنوات.
قانون العقوبات العراقي:
لم يحتوي قانون العقوبات العراقي على إشارة واضحة وصريحة للاختفاء القسري، ربما لأن أحد أركان هذه الجريمة هي مشاركة الدولة أو اعطائها الضوء الأخضر لإرتكاب هذه الجريمة، لكن وردت في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969م المعدل ما يسمى بالجرائم الماسة بحرية الإنسان، كالخطف في المواد (422) و(423) و(425)، والقبض والحجز في المواد (421) و(425) ق.ع، والاعتقال من دون أوامر قضائية، وبشكل عام فإنَّ المشرع العراقي أعطى لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في إيقاع العقوبة التي تصل في حدها الأعلى إلى خمس سنوات أو الغرامة وبحسب عمر المجني عليه ونوعه وطبيعة الاختطاف أو الاحتجاز والظروف المخففة أو المشددة للجريمة فهي جرائم لا تعدو كونها من وصف الجنح[2].
أما قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971م فقد نصت المادة (92) منه على أن (لا يجوز القبض على أي شخص أو توقيفه إلا بمقتضى أمر صادر من قاضي أو محكمة أو في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك).
بشكل عام لا يوجد نص في قانون العقوبات يجرم الاختفاء القسري بهذا المسمى، لكن المادة ٣٢٢ تتحدث عن الموظف الرسمي القائم بفعل الاحتجاز خلافاً للقانون وهي بذلك تشترك مع جريمة الاختفاء التي أحد عناصرها لأن شخص القائم بالفعل يحمل الصفة الرسمية أو يعمل بأشراف الدولة أو تحت سلطتها.
التحايل والخداع:
لقد كان نظام البعث خبيراً بأمور التحايل والخداع والمراوغة، فعلى الرغم من أن فعل الإختفاء القسري في العراق كانت تقوم به الأجهزة الأمنية أمام مرأى ومسمع ومباركة الدولة، إلا أن الأجهزة الأمنية كانت حريصة كل الحرص على أن يقدم ذوو المُغيب طلباً رسمياً الى القضاء بفقدان ولدهم، فقد كان النظام يروم من وراء ذلك حماية نفسه من المسائلة أمام الجهات الأجنبية، وبعد تقديم الطلب تبدأ عمليات البحث الصورية وفق الأوامر القضائية، ويتم التأكيد من قبل الأجهزة الأمنية إنَّه لا وجود للمفقود، وعندها يحصل ذوي المفقود على أمر قضائي بالفقدان، وتكون هناك نسخة منه لدى الأجهزة الأمنية لكي تواجه بها الجهات الأخرى، فيظهر الأمر وكأنه جريمة جنائية أو حادث عرضي لا علاقة لها بجريمة الاختفاء القسري، ولا تستطيع عائلة المُغيب أن تتجاهل تقديم الطلب الرسمي بالفقدان لأن الأمور الحياتية والتعليمات الحكومية كانت تقتضي من عائلة المفقود أن تبلغ عن الفقدان وفق مدد زمنية محددة لأمور أمنية وتنظيمية تتعلق بمكاتب المعلومات أو البطاقة التموينية، فضلاً عن أن عدم التبليغ يعرضها للمساءلة القانونية.
الجهات المتواطئة:
هناك جهات ومؤسسات عراقية تعاونت مع الجهات الأمنية واشتركت في الجريمة بشكل أو بآخر، ومنها دائرة الطب العدلي أو أقسام الطب العدلي في المحافظات العراقية، إذ أن أغلب المُغيبين قسراً كانوا يتوفون تحت التعذيب، وكانت جثثهم تنقل الى دوائر الطب العدلي التي كانت تلتزم الصمت مع علمها بسبب الوفاة على الرغم من أن مهمة الطب العدلي هو مساعدة القضاء في الوصول الى الحقيقة، أما الادعاء العام الذي يُعد الضمانة الأساسية لتحقيق العدل وحماية الأسرة والطفولة ورعاية القاصرين بما يمتلكه من صلاحيات واسعة في مراحل التحقيق والمحاكمة والطعن واصدار الحكم، فلم يكن يحرك ساكنا إزاء الجريمة على الرغم من علمه بها، ولاشك إن تلكؤ الادعاء العام يشير إلى تبعية السلطة القضائية وعدم استقلالها، ومن المؤسسات الأخرى التي لم تحرك ساكناً هي المؤسسة الإعلامية التي كانت على إطلاع واسع بأسماء المُغيبين قسراً، وهي الأخرى لم تكن مطلقة الحرية ولم تكن مستقلة اصلاً.
الآثار الاقتصادية للجريمة:
إن آثار جريمة الاختفاء القسري كانت تنسحب إلى عائلة الضحية، حيث تُصرف الأموال الطائلة وتباع المساكن والممتلكات في سبيل الوصول الى طريق يرشدهم لمصير الأبن أو الأب المُغيب قسراً، وكانت العوائل العراقية تقع ضحية لجرائم الابتزاز التي يقوم بها منتسبو الجهات الأمنية، وكانت خيبة الأمل كبيرة لديهم عندما يعلمون بوفاة ولدهم بعد أن خسروا أموالهم وممتلكاتهم، وهكذا كانت الجراح تتجدد كل يوم وتتلبد أجواء الأسرة بغيوم الحزن والمأساة، وغالباً ما تقوم الأم بدور الأب والمعيل في الوقت نفسه، وقد تتعرض نتيجة لذلك للمضايقات وتقع ضحية للعنف بشتى أنواعه، وتواجه النساء تحديداً صعوبات في تحديد وضعهنّ، فهن يعشنّ حالة مبهمة تتأرجح بين الزوجة والأرملة، حيث يرفضنّ الزواج مجدداً ما لم تتوفر معلومات مؤكدة عن مصير أزواجهن على الرغم من مضي سنوات على جريمة الاختفاء القسري، أما الأمهات فكان حزنهنّ يتجدد، ولا توجد أي كلمة من كلمات العالم تخفف من جزعهنّ بعد فقد أبنائهنّ وأحبابهنّ.
ومن الجوانب التي ترتبط بالاختفاء القسري هو الجانب الاقتصادي للعوائل التي غُيب بعض أفرادها وغالباً ما يكون المُغيب هو المعيل الرئيس للأسرة، فتقع الأسرة تحت طائلة الفقر العوز، ولم يكن نظام البعث يوفر مصادر معيشة للأسرة أو إعانة من شبكة الرعاية الاجتماعية، وهو الآخر يتنافى مع المادة (22) من الإعلان العالمي لحقوق الانسان التي يتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومنها الحق في الضمان الاجتماعي.
الآثار النفسية لعائلة المُغيبين:
إن الاختفاء القسري للأب أو المعيل أسهم بشكل كبير في تهميش العائلة العراقية، وفقدان المرشد والموجه، وتعرضت امهات وزوجات المُغيب لحالات نفسية ومرضية متعددة لعدم علمهم إذا كان الضحية لا يزال على قيد الحياة او لا، وإذا كان الأمر كذلك فأين يحتجز، وما هي ظروف احتجازه، وما هي حالته الصحية ممّا يضع أفراد العائلة في موقف يصعب إستيعابه، كما إن أسرة الضحية تدرك تماماً انها مهددة كذلك، وأن البحث عن المُغيب قد يعرضها للخطر، وتفشت ظاهرة التسرب من المدرسة وعمالة الأطفال والتسول، وهذا يُعد خرقاً واضحاً لأحكام اتفاقية حقوق الطفل، بما في ذلك حقه في التمتع بهويته الشخصية، كما أن حرمان الطفل من أحد الوالدين عن طريق الاختفاء القسري يشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الطفل.
إنّ وجود شخص مُغيب يزيد من الصراعات العائلية حيث يلجأ الأفراد إلى العزلة وإهمال العلاقات مع المجتمع، ويستمر الهوس بمصير الشخص المفقود داخل الأسرة، كما يوجد تضارب في آراء الأفراد حول ما حدث للشخص المفقود في كثير من الأحيان، مما يزيد من الصراعات العائلية.
ويلحظ إنَّ العائلة العراقية التي لديها مُغيب تحاول أن تتواصل مع عائلات أخرى في المجتمع ممن لديهم مفقودين أيضا، لتبادل الآراء ومساعدة بعضهم البعض، ولا تقتصر آثار الفقد على عائلة المفقود، بل تتسع لتشمل أصدقاءه وزملاء المهنة والدراسة.
اتباع المُغيبين قسراً:
ومن الجوانب التي لم يسلط عليها الضوء بالقدر الكافي هو مصير أتباع من تم إخفائهم قسراً، فهناك شخصيات دينية معروفة، وأخرى شخصيات أدبية أو فنية أو رياضية، فهؤلاء فقدوا جانب مهم من جوانب البناء المادي والمعنوي، ومن الذين غيبوا قسراً على سبيل المثال لا الحصر السيد عز الدين بحر العلوم عام 1991م عقب الانتفاضة الشعبانية وكان الأخير أبرز أساتذة الحوزة العلمية في النجف الأشرف لسنين طوال، والجدير ذكره إن جريمة الاختفاء القسري لا تقتصر على من هم داخل العراق بل امتدت الأذرع لتغييب من في الخارج ممن يعتقد النظام أنهم يشكلون خطراً عليه.
[1] الجريمة المستمرة عكس الجريمة الوقتية فهي تحتمل بطبيعتها صفة استمرارية السلوك الإجرامي (علي حسين الخلف وسلطان الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، العاتك لصناعة الكتب، بغداد، ص311)
[2] للمزيد حول الجرائم الماسة بحرية الانسان ينظر:
جمال ابراهيم الحيدري، شرح احكام القسم الخاص من قانون العقوبات، مكتبة السنهوري، 2013، ص 320.