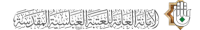حمائم في قفص الإتهام..!
كوثر العزاوي
وقتٌ لا يكاد يُقدَّر، لا بالدقائق ولا بالساعات، هو لا يَشبه أيّ زمان، وليس في طيّاتهِ آن، ولا يخمّنهُ عقل حاذق مهما بلغت حذاقته مالَمْ يُقِيم ولو وطَرًا في ذلك المقطع من الزمن الغابر! لِما انطوت مسافاته على وقائعَ خانقة كاتمة، تستهدف الروح والعقل قبل الجسد البالي، إنه أحد الأساليب الإجرامية التي اعتمدها أوباش البشر من حثالة البعث الظالم بحق السجناء والسجينات قبل المحاكمة بهدف قمعِ ما تبقى لديهم من طاقة وقوة، واستنزاف القدرة على التحدّي والصمود وخنق الأنفاس الأبيّة، ولكن هيهات!! فلو نَفَدَت كمية الأوكسجين فلم تغبْ ولن تَنفَد عنايات الله تعالى، بل ولن تنقطع ألطافهُ عن المستضعفين وهم بعينهِ التي لا تنام!
-كان يوماً عسيراً من أيام الشهر الثامن من عام ١٩٨٢م، وتلك الأيام التي عُرفَت بضراوة حرّها من صيف العراق اللّاهب! فُتِح باب ما يسمى -بالموقف- وهو أحد دهاليز الأمن العامة النائية عن أحاسيس البشر وأنظارهم، دخل احد ازلام القمع الصدامي ووقف على عتبة تلك الغرفة المكتظة بالنساء، فتيات بعمر الورد وأمهات منهكات، ثم قال: أي واحدة تسمع اسمها تتقدم هنا: أخذَ يُذيع الأسماء حتى بلغ العدد ال١٧ معتقلة كنت أنا إحداهنّ وأشار إلينا أن اخرجنَ ورائي، وكنا لا نملك شيئا يستوجب استعدادًا أو يُلزِمُ وقتًا، فقد كنّا نرتدي رثّ الثياب وعباءاتنا هي الأخرى نالتها سياط البعث ليَبلى الجزء الأكبر منها وقد أبَت إلّا الحفاظ على بقايا أجساد لسَترِ جراحاتها، ودّعنا مَن بقيَت من السجينات في عناقٍ ودموع وتمتمات الرضا بالقضاء حيث لا نعلم إلى أين بعد إقامة أشهر أقلها السّتة شهور، وعلى أيّة حال فالمصير مجهول والوِجهة مبهمة، ونحن بين الأمرين نُساق عنوة لا نعلم قدَرنا وإلى أين مآلنا؟ ولعلّ أقرب ما يخطر على البال آنذاك هو ما حصل للعشرات من الأخوات المعتقَلات قبلنا حينما أخذوهنّ بالأسلوب القسريّ نفسه ولم يعُدنَ، فيما تبيّن بعد التغييب أنهن قد أُعدِمنَ وتمَّ دفنهن في مقبرة جماعية وإلى اليوم مازِلنَ مجهولات الأثر.
-على كل حال- خرجنا بقلوب تعلقت ببارئها وألسِنةٍ لم تنفك تلهج ذاكرة ربها ومَن عَليهم المعوَّل في الشدائد محمدٍ وآل محمدٍ “عليهم السلام”، أركبونا جميعا في سيارة بتصميم صندوق حديدي بلا نوافذ، تشبه برّادات نقل اللحوم في الوقت الحاضر، ولم نرَ من خلالها أيّ مَعْلَم من مَعالِم الطريق ولا بصيص من ضوء النهار، وكانت بيننا تلك الطفلة الرضيعة مع أمها التي جاءت بها حاملًا وَوُلدتها في الموقف، “دعاء” ابنة الشهيدة عواطف التي حُكمت مع زوجها بالإعدام، لقد كانت معي في قفص المحكمة نفسه “قفص الاتهام” فلم أنسَ حال الطفلة وهي تتلوى عطشًا من شدة الحرّ وكأنها حمامة تحتضر! فو الله إنّ ذلك المشهد لأشدّ عسرًا وصعوبة من أن تتحمله الجبال لا البشر والطفلة تكاد تلفظ آخر أنفاسها، وذلك العدد يستنجد طالبًا نسمة هواء، حيث أخذنا نصرخ ونضرب على جدران السيارة بلا شعور من شدة الإعياء جراء نفاد الأوكسجين في تلك السيارة اللعينة وهي تسير في الشارع مترنّحة كأنها وحش ينقل فريسته منتصرًا، وليت من غفل من الناس والمارّة عَلِموا ما تحملُ تلك السيارة الصمّاء من لحوم بشرية ببقايا حياة ونبضات واهنة والروح فيها تصطرخ تلتمسُ الهواء أو قطرة ماء!! ولكن أنّى لهم معرفة ذلك في عالَمِ الضجيج، والغفلة عن حقبةٍ غيَّبها طاغوت العراق حقدًا وانتقامًا من شريحة رفعت راية الرفض بأيدٍ بيضاء لشباب وحرائر عارضوا نظامه الدمويّ الذي سبق وأن باشر مجازر الذبح والتغييب لآلاف الشرفاء والأحرار منذ منتصف السبعينيات وحتى أيام سقوطه مذلولًا مخذولًا، ولم يرعَوا حرمةً لعلماءٍ، وأدباء، وطلبة جامعات، ومربّين، ومن كل فئات الشعب العراقي رجالًا ونساءً، شيبًا وشبّانا حتى خلَت تلك البيوت من ذوات العفاف والشرف والنبل والمسؤولية، ليُودِعنَ فتيات أجمل سنين العمر بين قضبان السجون أو الموت على مشانق الإعدام لتلقى نفوسهنَ بارئها صابرة محتسِبة!
وشيئا فشيئا أخذت سرعة السيارة بالتضاؤل، ولم نكَد نصدق حينما توقفت السيارة حقا! نزلنا في مكان ليس على خارطة العالم مثيله! إذ لم تلحق عيوننا تشخيص معالمه، حتى أنزلونا في قاعة كبيرة وفيها من المقاعد الكثير، عرفنا أنها قاعة الانتظار قبل الدخول إلى قاعة محكمة الثورة سيئة الصيت، هذا الأُسلوب معروف لدى البعث المجرم، ففي قانونهم إنّ المعتقلين بقضايا إسلامية وبعد غلق ملفات قضاياهم يتم إرسالهم إلى المحكمة الصورية للاستماع إلى الأحكام المجحفة الصادرة بحقهم ظلمًا وعدوانًا قبل التسفير إلى سجن الرشاد بالنسبة للنساء. وسجن أبي غريب للرجال!! وكان ما كان في قاعة المحكمة وبعد المحاكمة وصولًا إلى سجن الرشاد وما أدراك ما سجن الرشاد!!