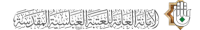صدام في ذاكرة صديق طفولته
د. قيس ناصر
باحث وأكاديمي
رفاق طفولته لم يسلموا من جرائمه وبطشه، ممن يعرفونه على حقيقته، إذ أعدمهم أو غدر بهم، ليمحوا ماضيه، وكل من يُذكره به، بعد أن تمكّن من المال والسلطة، بعد فقر وجهل، مستثمراً، كمية الشر والقسوة المختزنة داخله، هكذا يتحدث من نجا منهم، محاولاً، الكتابة عنه من أجل كشفه للعالم، الذي جهله حتى ذاق ويلاته، وبقي بعضهم يلمع صورته، نتيجة ما كان يحصل عليه من هدايا ومُنح، كشفت عنها عطايا النفط التي وجدت بعد سقوطه، وإلى اليوم، هناك من تبرع لتلميعها مرة أخرى، انطلاقاً، من دوافع الجهل لديه أو أنه وجد فيه تحقق الصورة التي يخفيها عن شخصيته هو، في كل ما يمت للشر والقسوة بصلة .
يتحدث إبراهيم الزبيدي صديق طفولة صدام عن بيئة ومكان ولادة الأخير، في قرية العوجة، ولاسيما في كتابه دولة الإذاعة، الذي أشار فيه إلى أن تسميتها ليس نتيجة إعوجاج الموقع الجغرافي، إنما مرتبط بالسلوك أكثر منها بالموقع الجغرافي، وجاءت التسمية من أهل العوجة، وإن من سمات ساكنيها الفقر المدقع وقلة المتعلمين منهم في ذلك الوقت، بل ندرتهم على حد تعبيره، ويصفهم بأنهم إلى فترة كتابته عنهم في تسعينيات القرن العشرين، لا يحترمون المتعلم ويحتقرونه، وهذا الأمر انعكس على علاقتهم مع التكارتة مع استلامهم للسلطة، إذ طالهم عقابها ولا سيما أبناء عمداء العشائر والأسر التكريتية الكبيرة، في هذا السياق، يذكر الزبيدي أن والده كان يوبخه على علاقته بأهل العوجة وعلاقته بصدام بشكل خاص، التي يصفها بالعلاقة المشينة لما يمتلكه صدام من ميول شريرة .
وتماشياً مع ما تمَّ ذكره، في وصف البيئة المجتمعية والأسرية كما يتحدث عنها الزبيدي، فإنها بيئة مجتمعية رفت بالقسوة والتهور والعنف، وبيئة أسرية أبرزها نفور زوج أمه إبراهيم الحسن منه، بل أنه لم يطيقه، وكان صدام يعيش متنقلاً بين منزل خاله خيرالله طلفاح في الصيف وخالته ليلى طلفاح وزوجها أحمد العبد، الذي سرق دجاجة من جارته، في الشتاء، وكلمة منزل ليست الوصف الدقيق أو الصورة المرسومة في الذهن للسكن، إذ أنه ليس داراً، إنما غرفة مخصصة للنوم والطبخ والجلوس تجمع كل أفراد الأسرة، هذا حال دار إبراهيم الحسن، وكان صدام نحيفاً جداً وضعيف البنية، وهوايته صيد السمك بواسطة المتفجرات التي يصنعها بنفسه، في طريقة صيد جائرة غير مشروعة .
في مدرسته، لم يسلم من شره أساتذته، إذ أنه هجم على أخ أحد مدرسيه في منزله وأطلق عليه النار وفرّ هارباً، وعلى الرغم من أن السلطة حينذاك لم تستطع إثبات جريمة صدام، إلا أنه برر فعلته للزبيدي، بأن القدر قد وضعه في طريقه ودفعه إلى قتله أو قتل أخيه، والدنيا كلها منذ بدء الخليقة مقسمة على قوي وضعيف، شجاع وجبان، غني وفقير، سادة وعبيد، قادة ورعايا. هذا السلوك هو الذي كان يحكم علاقة صدام بالآخرين، ولخصه بنفسه.
بالتأكيد أن سلوكه لم يكن نتيجة رؤية أو قراءة معرفية، إنما من خلال السماع لخاله طلفاح، ومشاهداته لسلوك بيئته، وفهم العالم من خلالها بعد أن قلب القيم الأخلاقية، وعرّف منطق التهور والقسوة والشر بأنه شجاعة من خلال السلوك الذي تبناه، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أن السرقة شطارة، السرقة التي تمثلت في بداياتها بالمشاركة، بسرقة الأسمنت من إحدى الشركات العاملة في تكريت لصب أرضية منزل خالته، أو سرقتهم للتيار الكهربائي للتهرب من دفع الأجور في منزل خاله خيرالله طلفاح، الذي حرض صدام للاعتداء على متحصل أجورها بعد أن كشف سرقتهم.
هذا السلوك هو الذي حكم سياسة صدام بعد هيمنته على حكم العراق، فالسرقة توّجها بسرقة الدولة كلها، والشر لم يقف لديه عند القتل والتهجير لشعبه، ومن يختلف معه، إنما سياسة الشر قد حكمته .
في سياق القيم الأخلاقية أيضاً، صدام يصف صديق طفولته بالجبن لأنه وجد محفظة نقود تحتوي 54 ديناراً وأعادها الى صاحبها، واعترض على هذا السلوك، أما عن الأسلوب الذي وظفه صدام في استمالة قلوب الأقربين والأبعدين بعد أن أصبح نائبا لرئيس الجمهورية، وبداية مسيرته للانفراد بالعراق وبكل ما يحتويه، هو نثر المال العام والهدايا والاكراميات، في سياسة دلالتها تُعبر عن الذحل كأعلى حالات الحقد لكل محترم، مفادها من كنتم لا تحترمونه أمس، اليوم يمنحكم العطايا والاكراميات !!!!!
تعبير دقيق استعمله الزبيدي لوصف دور صدام في عمليات القتل، بعبارة ( القتل مفتاح الفرج)، فأول تكليف له بعملية القتل قد تمت في 14 تشرين الأول 1958 نفذها بناءً على توجيه خيرالله طلفاح بقتل سعدون الناصري أحد قادة الحزب الشيوعي في تكريت لمصالح شخصية مرتبطة بطلفاح، هذه الحادثة التي عرّفت قادة حزب البعث بوجود قاتل يمكنهم الاعتماد عليه لاحقاً، في عمليات القتل التي سينفذونها، ولا سيما حادثة اغتيال عبد الكريم قاسم في تشرين الأول 1959، وبعد تلك الجريمتين لمع اسم صدام كمغامر في القتل، بمعنى آخر أن صدام لم يُعرف إلا من خلال ممارسة القتل، فلا توجد سمة أخرى عُرف بها سوى القتل والغدر والسرقة، فالشر هو بضاعة صدام الوحيدة لهذا وقع عليه اختيار أحمد حسن البكر .
يشير الزبيدي أنه بسهولة قد أدرك صدام أن قيادات حزب البعث مجموعة من الفاشلين في الدراسة أو المطرودين، وأنهم ليسوا قيادات كما كان يظن، وهذا الأمر شجعه للانغماس في هذه المجموعة، بعد أن اطلع على هشاشة أغلب أولئك القادة وانحراف أخلاق بعضهم وجبن بعضهم الآخر، وهنا، أدرك صدام أهمية الانتماء إلى هذا الحزب بوصفه فرصة ذهبية تحقق طموحاته وتنصف ذاته أمام خاله طلفاح الذي اعتبره فاشلاً، لا يصلح لشيء أكثر من الخدمة في منزله ورعاية النساء في غيابه، فضلاً عن أن الانتماء إلى حزب البعث، يحقق حلمه بالحصول على مقعد في الحكومة بعد فشله بالدراسة ويأسه من الحصول على وظيفة بالطرق السلمية .
تتلخص شخصية صدام على وصف الزبيدي بالآتي: (الحرمان، الحقد، الطموح، اللهاث وراء أية فرصة للصعود، وينتمي إلى عشيرة متطبعة بالخشونة والميل إلى العنف والاغتيال لا يستحون ولا يقيمون لله حرمه)، ويمكن إضافة أو تأكيد لما ذكره الزبيدي بـ هيمنة الذحل، ذحل العبيد للسادة، وهنا الأمر لا يرتبط بالتقسيمات التي سادت في العصور الماضية، بقدر ما هو طريقة تفكير قد هيمنت على تفكير صدام وسلوكه، فعلى الرغم من المناصب التي استولى عليها، إلا أنه بقي حاقداً على كل انسان سوي ومتعلم، فالحرمان والفقر، ليس تبريراً لسلوكه، فالتاريخ يشهد أن العديد من العظماء كانوا فقراء ومحرومين، إلا أنهم قدموا للإنسانية الكثير، إلا أن سلوك صدام قد سيطر عليه الذحل والقسوة، الأول بوصفه شكلاً من أشكال الحقد والدونية التي لا يعوضها شيء سوى الانتقام من كل شخص يجعله يُذكره بنقصه، والثانية بوصفها تمثيلاً للشر.