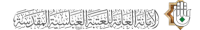نحو اجتثاث ظاهرة التطرف وتفكيك خطاب الكراهية
أ.د. حسين الزيادي
إنَّ اجتثاث الأفكار المتطرفة ، وتفكيك خطاب الكراهية ضرورة عالمية تستحق أقصى درجات الاهتمام والعناية، إلا أن ما يؤسف عليه أن أرضية التطرف والكراهية في منطقتنا العربية تكاد تكون خصبة في نفسية البعض مع الاحتفاظ بجانب النسبية في القول، فهناك بيئة مجتمعية متعاطفة مع ثقافة الكراهية، ولا أدل من نجاح دعاة (ثقافة الكراهية) في اختراق البيئة المجتمعية، أن (53%) من المشاركين في أحد الاستفتاءات اعتبروا أن قطع الرؤوس في العراق عمل من أعمال المقاومة، بحسب أحد الاستفتاءات الالكترونية في إحدى الدول الخليجية، وأيّد (55%) منهم فتوى قتل المدنيين المتعاونين من الاحتلال وعدّوها مقاومة، وفي ظل هذه البيئة المتعاطفة مع خطاب الكراهية والمشبعة بتخوين الآخر، لا عجب أن يكون (الزرقاوي) في نظرهم شهيداً و(بن لادن) مجاهداً إسلامياً و(صدام) بطلاً قومياً، وبات قتل المدنيين جهادا ومقاومة.
تكمن خطورة التطرف بوصفه مرتبات يقود بعضها إلى بعض وصولاً إلى قمة التطرف وهو العنف المسلح واستعمال القوة والإكراه، وهو فكر يغذيه خطاب الكراهية، فالتطرف جسر يقود إلى ضفة العنف والإرهاب، لاسيما إذا اقترن بأجندات سياسية وحزبية وتنظيمية، وتبدو عملية تفكيك التطرف بالغة الصعوبة، بعد عقود من هيمنة ثقافة الكراهية وخطاب رفض الآخر، مع فكر ديني أصولي متزمت واحتقانات اجتماعية مدمّرة، لذا بات التخلص من التطرف وانتزاعه من داخل الإنسان، ومن ثم من بنية المجتمع، عملية تغيير مؤلمة ومستعصية تحتاج إلى قرارات تبدو للمتطرف متطرفةً، وعندما نريد من المتطرف أن يتحلّل من فكره المتطرف لإنقاذه وإنقاذ المجتمع من سلوكه الانتحاري، فإننا ندفعه إلى ما يعتبره هو انتحاراً نفسياً.
ثقافة الكراهية هي توليفة من عنصرين هما: (التكفير والتخوين) فإذا كان الديني يكفر على الهوية، فإن القومي يخون الآخر بمجرد تعارض الآراء، في ادعاء شمولي يحتكر الدين والوطنية ويمنعها عن غيره وما كان لهذه (التوليفة المتعصبة) أن تكون (توليفة متفجرة) إلا بفعل التحريض المستمر من قبل منابر التحريض واتساع نطاق خطابها في ظل الفضائيات والمواقع الالكترونية المنتشرة، فكانت النتيجة اشلاء متناثرة من جثث الابرياء وجيوش من الأرامل واليتامى، وكان العراق أولى الدول التي ابتليت بهذا النوع من التطرف والإرهاب.
إنَّ المعتقدات المتطرفة وإن كانت غاية في السذاجة والسخف وعدم المقبولية فهي راسخة القوة في وجدان المتطرف ، و جزءاً جوهرياً وصميمياً من نفسيته، وليس مجرد سمات وملامح قابلة للتعديل لذلك عندما نخالفهم ونتحدى أفكارهم فإننا بالفعل نطلب منهم أن يُغيّروا كثيراً من ماهيّتهم وذواتهم، وهذا من منظورهم يشبه الانتحار النفسي، الأمر الذي يجعل تكلفة التغيير باهظة جداً، أما الردود العلمية والفقهية والفكرية على المتطرفين، فإنها تفيد المعتدلين ولا تؤثر على المتطرفين، لذا فاغلب الاشخاص المتطرفين الذين تم القاء القبض عليهم لم يتخلوا عن أفكارهم المنحرفة، بل أن بعضهم اكد انه لو خرج من السجن لعاد الى فعله الإرهابي الذي سجن لأجله، فهو يعده جهاداً .
يذهب بعضهم إلى أن التطرف الديني ترجمةً لفشل مهني أو دراسي أو اجتماعي أو أسري أو روحي وعدم قدرة على تحقيق الذات على المستوى الفردي، الأمر الذي يدفع المتطرف للتفاخر بانتمائه إلى إطار اجتماعي، كالهوية أو الطائفة أو القبيلة، سعياً لتعويض ما يعانيه من نقص الإنجاز والحاجة للتقدير الاجتماعي، ولاسيّما إذا كانت الثقافة الاجتماعية تحتفي وتعتد بهذه الانتماءات، ومن هنا بات الاهتمام بالجانب الشخصي والخدمي أمر على جانب كبير من الأهمية، لكن هذه النظرية ربما تصطدم بنماذج واقعية لم ينقصها الانجاز الشخصي المهني مثل زعماء داعش والقاعدة وهو أمر يمكن إرجاعه إلى الانهزام النفسي أو الإنساني أو الاجتماعي، أو ممثلاً في أزمة وجودية أو روحية، وليس بالضرورة فشلاً مادياً على صعيد المهنة أو التعليم أو المكانة الاجتماعية أو الوضع الاقتصادي.
ومن القضايا اللافتة، في مسألة تفكيك التطرف، انتماء النساء للحركات المتطرفة أو الجهادية أو القتالية، على الرغم من الموقف المتزمت لهذه الحركات اتجاه المرأة وحقوقها وتهميشها واعتبارها سلعة تباع وتشترى، ولذلك لوحظ انخراط نساء في جماعة داعش فكرياً أو تنظيمياً، ويؤكد هذا السلوك الاضطهاد الذي تتعرض له المرأة ، حيث أصبحت النساء أنفسهن جزءاً من الوعي الاجتماعي المُنتهِك لحقوق المرأة، والذي يعبّر عن نفسه أيديولوجياً وحزبياً في حركات الإسلام السياسي التي ترفض مثلاً تولية المرأة للمناصب العليا في الدولة.