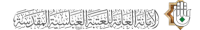في ذكرى مجزرة سبايكر التاريخية:
بين مجتمع الأحياء ومجتمع الأموات!
سعود الساعدي
باحث في الشأن السياسي والإعلامي
عندما تتكرر المآسي والاحزان، وتتجدد المجازر والمقابر، لتتوالى الكوارث السياسية والزلازل الاجتماعية، ويواصل منبع الدم سيلانه دون انقطاع، وتصبح ثقافة الموت بالجملة وبالتقسيط أمرا عاديا! ليس موت الحياة، وهي الشهادة التي تخلد المُضحي وتحيي أموات الحياة، الذين عاشوا باجسادهم دون ارواحهم ونفوسهم ووجودهم,وإنما ثقافة حياة الموت وأموات الحياة، التي تستهدف قيم الكرامة والحرية والشعور بقيمة الوجود والعيش الكريم، لتصيبها بمقتل بطيء متدرج عظيم، ثقافة تستهدف الذاكرة وتنخرها والاذهان وتسطحها والنفوس وتخدرها، لتقدمها الى المسالخ جاهزة!.
عندما تتكرر أعاصير المجازر وكوارث المقابر الجماعية، ويتم إعادة تدوير وإنتاج القتلة والمجرمين في مجتمع من المجتمعات، فهذا يعني أنه مجتمع مكشوف وبلا مظلة أخلاقية واقية، مجتمع مسلوب الإرادة مشلول الذاكرة ومنعدم الهوية، بلا مصدات ثقافية عميقة ولا موانع وقائية متينة، ولا نخب مؤهلة متصدية تمارس دور جرس الإنذار قبل أن تُشن غارات الأعداء، وقبل أن تُقصف البنى التحتية الاجتماعية والقيمية، لا لتنبه وتحذر وتقي فقط، وإنما لترمم الهوية وتعيد إنتاج الثقافة وتستذكر الكوارث والمجازر التاريخية، فتؤرشفها وتؤرخها لتحترم كرامة شعبها، وتطالب بحقوق ضحاياها، وتحولهم إلى رموز نضال وحرية وكرامة ومصدات وقاية وحماية مستقبلية! بعد أن تقتص من الجناة، فهي هنا لا تحيي فتن الماضي، بل تحمي الحاضر وتقي المستقبل وتنميه، حتى لا تتكرر المجازر ولا يُعاد إنتاج الواقع بأدوات وأفكار الماضي، لكن الكارثة أن المجتمع الضحية لم يتعرف على القتلة وأساليبهم ليوقفها، رغم تكرارها واستنساخها، بل أن القتلة خبروا ردة فعل الضحية، وقرأوا عقله ودرسوا نفسيته، فعرفوا كيف يقتلونه مرات اخرى!
هذه الصفات الأمراض التي تصيب المجتمع المكشوف “المفضوح”، ليست وراثية وإنما مكتسبة، ونتيجة تخطيط “مؤامرات” لأجهزة مخابرات عريقة، لسنوات بل لعقود من الاستهداف المتدرج والبطيء، والقتل الصامت والنخر العميق لأسس المجتمع الأخلاقية والثقافية.
الجرائم التي ترتكب بحق هذا المجتمع لا تقتله مرة واحدة، بل تقتل أجياله وتاريخه وقيمه وثقافته مرات ومرات، ليس لأنها جرائم غير معلنة ومن نوع آخر لا يحاسب عليها القانون، جرائم ثقافية واجتماعية وقيمية وفكرية ونفسية فقط، لا تحدث جرحا أو تسفك دما بشكل مرئي، وإنما ايضا لأنها تستهدف وتقع في مجتمع “ظواهري” حسي مسطح، لا يشعر بآثار الجريمة إلا بعد أن يراها أو يتذوقها أو يسمعها أو يلمسها أو يشم رائحتها، وإلا بعد عقود من ارتكابها، فهو ليس مجتمعا تحليليا واعيا مبصرا، يتلمس ويستشعر ويتحسس، ليفكر ويدقق ويحلل ويركب، ثم ليستشرف ويستقرئ ويستنتج!. لا يستنتج “النتائج المحجوبة” فقط، وإنما ينتج أيضا ثقافة أصيلة، تولد من رحمها إرادة سياسية وطنية صلبة.
ولأنه مجتمع أيضا لا يؤمن بنظرية المؤامرة، وتستنكر وتستسخف نخبه الثقافية المصنوعة المستأجرة والمتسكعة الحديث بها، فصناعة التفاهة هي أولويتها ووظيفتها، ليست التفاهة في الثقافة أو الوعي أو التفكير أو المواقف السياسية، وإنما حتى في الذوق والأكل واللبس والشرب والمشي واللعب! فمن الطبيعي أن يكون النتاج مجتمعا متهالكا ومخدرا، يحمل فكرا تبريريا وروحا إنهزامية، مجتمعا عاجزا وانفعاليا يساوم على قضاياه الوجودية والوطنية، ويردد افكار اعدائه ويتقبلها، بعد أن فقد ثقته بنفسه واستغرق بمشاعره ومصالحه الذاتية والفئوية ليتحول إلى مجتمع عميان! بل باتت فيه الخيانة وجهة نظر معلنة بكل وقاحة في المحافل الاعلامية والسياسية! ودون اكتراث لتجارب الخونة الذين انكشفوا بعد أن تركهم اسيادهم عبر التاريخ بعد أن رحلوا.
مجتمع يساوي بين الضحية والجلاد، بين القاتل والمقتول، هو ليس مجتمعا بل مقبرة كبيرة، بلا مستقبل محمي ولا أسوار وقاية، مجتمع منخور بانتظار العاصفة لينهار!.
قراءة المستقبل بناء على تجارب الماضي الدموية، ليست كقراءة الكف والطالع، وليست تشأوما وسلبية وجلدا للذات، بل هي صناعة أمل وحياة، وصرخة تفاؤل ودعوة للحفاظ على ما تبقى من الحرية والكرامة، ومحاولة لإيقاف الخداع والتزوير والكذب المركب والمتراكم.
الثقة الزائفة بمستقبل آمن، دون صناعة لأسس الأمن هي حماقة, والوقوع في نفس الفخ، واللدغ من ذات الافعى هو عمى. وتقديم قوافل الموت الرخيص بلا هدف الحياة، هو غباء ومن يهن يسه